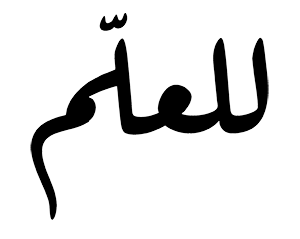الإسلام السياسي في المنطقة العربية: إلى أين؟!
من المعروف أنَ بدايات الإسلام السياسي المُنظّم في المنطقة العربية تعود إلى عام 1928، حين أنشأ الشيخ حسن البنا تنظيم " الإخوان المسلمين" في مصر، وقد ظل هذا التنظيم حتى أواخر الأربعينيات، تنظيماً دعوياً اجتماعياً إرشادياً بعيداً عن العنف، إلى أن تمَ إنشاء ما سُمي " بالنظام الخاص" في إطاره. والذي أُتهم بقتل الشيخ الخازندار في عام 1948، وبمحاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في عام 1954.
والواقع أنّ النقلة الأساسية في مسيرة " الإخوان المسلمين" فيما يتعلق بالعنف، تعود في نظر كثير من المختصين والمتابعين إلى أفكار "سيد قطب" التي بثها في كتابه الشهير (معالم في الطريق) والتي اعتبر فيها أن المجتمع العربي والإسلامي المعاصر هو "مجتمع جاهلي" متأثراً في ذلك بأفكار الشيخ الباكستاني "أبو الأعلى المودودي"، وقد يكون انتصار الثورة الإسلامية في إيران (1979) قد ساعد بدوره على ظهور الاتجاهات الإسلامية المتطرفة التي رأت أنَ الثورة والعنف هي السبيل إلى الوصول إلى " المجتمع المسلم الذي يحكّم الشريعة الإسلامية" في كافة مناحي الحياة، ومن المؤكد أن تراجع المد القومي العربي بعد وفاة رائده الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1970، كان عاملاً مهماً في تنامي التيارات الإسلامية واعتقادها أنَ هذه هي فرصتها في تسَيد المجتمعات العربية والإسلامية، ومن هنا ظهرت التنظيمات "الجهادية السلفية المقاتلة" " كالقاعدة" التي تبنت المسؤولية عن أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وكداعش (الذي تَسمّى أخيراً بتنظيم الدولة) والذي استولى على مساحة كبيرة من سوريا والعراق قبل انكساره في كلٍ منهما مع نهاية عام 2017، وغني عن القول أن هزيمة "السلفية الجهادية" لا تعني انتهاء وجودها كلياً إذْ ما زالت "قوات" و"خلايا" كثيرة لها في المنطقة العربية وخارجها (سوريا، العراق، اليمن، الصومال، مالي، أفغانستان..). ولكنها في الحقيقة ضَعُفت إلى درجة كبيرة، ولم تعد تشكل خطراً حقيقياً على المجتمعات والدول التي تتواجد فيها.
أمّا "الإخوان المسلمين" الذين مثلَوا تقليدياً الإسلام السياسي المعتدل، كما يظهرون علنا في أدبياتهم على الأقل، فقد تعرَض لانكسارات حقيقية في العقدين الأخيرين في المنطقة العربية، حيث انتهى حكم الرئيس الإخواني المصري "محمد مرسي" بعزله من قبل الجيش بل باعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2013، وقد لحقت السعودية بمصر في ذلك في عام 2014، والإمارات العربية المتحدة في عام 2015، أما في تونس فقد خسرت "حركة النهضة" وضعها باستيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في عام (2019) ووضعه رئيس الحركة (راشد الغنوشي) في السجن، كما خسر الإخوان الانتخابات (بزعامة عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني) في المغرب لصالح حزب "الاستقلال" والأحزاب الأخرى، ولا ننسى طبعا خسارة الإسلام السياسي في السودان، حيث كان الرئيس السابق (عمر البشير) رئيس " المؤتمر الوطني" ذا اتجاهات إسلامية واضحة، وقد كانت الخسارة الكبيرة الأخيرة لهذا التيار السياسي الإسلامي حل جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، واعتبارها جماعة غير شرعية ومُساءَلة كل من ينتمي إليها، برغم العلاقة التاريخية والخاصة بين الإخوان والنظام السياسي الأردني، ولمدةٍ زادت عن ثمانين عاماً.
إنّ طبيعة هذه المسيرة للإسلام السياسي (الجهادي السلفي المقاتل والمعتدل) يجب أن يدعو إلى التفكير والتساؤل: لماذا واجه الإسلام السياسي كل هذا التعثر برغم أنه يستمد طروحاته - كما يقول- من ثقافة الأمة ودينها السائد؟
إنّ هنالك العديد من الأسباب التي قد تعلَل هذه الظاهرة وقد نلخصها على النحو الآتي:
أولاً: اعتماد الإسلام السياسي أسلوب " الأسْتَذة" في الطرح، واعتبار أن ما يدعو إليه هو مما "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" كما يقولون، باعتبار أنه مُسَتمد من الدين، ولا مجال لمناقشة الدين وإلا وصل الأمر إلى حدود "الزندقة" و"الكفر"!
ثانياً: النظرة "الماضوية" فهم يريدون تطوير المجتمع الحديث لكي يكون على غرار المجتمع الإسلامي القديم متجاوزين في ذلك حقائق العصر، وتغير الظروف والأحوال، وتقدم التكنولوجيا، وغير ذلك مما يستوجب التوفيق الذكي والحصيف بين ثوابت الدين الحنيف، وطبيعة العصر ومتغيراته.
ثالثاً: القفز عن "البُعد الوطني" إلى "البعد العالمي" فيما يتعلق بمرجعيتهم فهذا التيار السياسي لا يؤمن بالأوطان والحدود بين الدول الإسلامية وذلك من منطلق وحدانية الأمة الإسلامية، وغني عن القول أن تيارات " الإخوان المسلمين" في كافة البلدان التي تتواجد فيها، تعتبر أنّ مرجعيتها النهائية هي " التنظيم العالمي" أو " الدولي" الذي يوجه الإخوان في كافة البلدان والدول، ويعمل على استعادة " الخلافة الإسلامية"، متناسيين أنه لم يعد بالإمكان قيام دولة دينية في العصر الحديث، وأنه من المتعذر واقعيا، توحيد ما يقارب "ملياري مسلم" في دولة واحدة، ولعلّ هذا السبب بالذات هو الذي أدى إلى خسارة "الإخوان المسلمين" مكتسباتهم في مصر، حيث انتماء المصريين لوطنهم العريق قوي وراسخ.
رابعاً: معاداتهم للديمقراطية (حكم الشعب)، وإيمانهم بالشورى التي لم تتبلور تاريخياً في العالم الإسلامي في صورة آلية "ديمقراطية" يتم الرجوع من خلالها إلى جماهير الشعب، والتي تضمن الخلاص من الاستبداد السياسي، والمحافظة على حقوق الإنسان، وغير ذلك من مفردات "المنظومة الإنسانية" التي أجمعت عليها كافة شعوب العالم، وترجمتها في مواثيق الأمم المتحدة. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن الإسلام السياسي المتمثل في الحركات الجهادية السلفية لا يؤمن أصلا بالديمقراطية، أما التيار السياسي المعتدل فهو يتظاهر بالإيمان بها، وقد يشارك أحياناً في فعالياتها ولكنه في الواقع يعبّر عن نزعة إقصائية واضحة، عندما تتاح له الفرصة، وهو يعتبر أن مرجعيته هي "مكاتب الإرشاد الإخوانية" وليس الجماهير الشعبية.
هل معنى هذا التحليل أنّ "الإسلام السياسي" قد انتهى في المنطقة العربية والإسلامية؟ بالطبع لا، إنه قد تعرض لانتكاسات حقيقية لا يستطيع التغافل عنها، ولكن من واجبه في الواقع. - وعلى صعيد مفكريه ومنتسبيه- أن يعيد النظر في أطروحاته ومسلماته، لكي يعبر في رؤيته السياسية عن "الطموح" الإسلامي، وعن "روح العصر" في نفس الوقت؟ وإن يؤمن بصدق حقيقي عن قبوله بالديمقراطية (حكم الشعب) كآلية لحل الاختلاف مع التيارات السياسية الأخرى، وأن ينطلق في رغبته في التغيير من "احترام" للوضعية القانونية لكل بلد يتواجد فيه وصولا إلى التغيير السلمي الذي لا عنف فيه ولا دماء.
هل هذا ممكن؟ سؤال يظل برسم الإجابة!
والواقع أنّ النقلة الأساسية في مسيرة " الإخوان المسلمين" فيما يتعلق بالعنف، تعود في نظر كثير من المختصين والمتابعين إلى أفكار "سيد قطب" التي بثها في كتابه الشهير (معالم في الطريق) والتي اعتبر فيها أن المجتمع العربي والإسلامي المعاصر هو "مجتمع جاهلي" متأثراً في ذلك بأفكار الشيخ الباكستاني "أبو الأعلى المودودي"، وقد يكون انتصار الثورة الإسلامية في إيران (1979) قد ساعد بدوره على ظهور الاتجاهات الإسلامية المتطرفة التي رأت أنَ الثورة والعنف هي السبيل إلى الوصول إلى " المجتمع المسلم الذي يحكّم الشريعة الإسلامية" في كافة مناحي الحياة، ومن المؤكد أن تراجع المد القومي العربي بعد وفاة رائده الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1970، كان عاملاً مهماً في تنامي التيارات الإسلامية واعتقادها أنَ هذه هي فرصتها في تسَيد المجتمعات العربية والإسلامية، ومن هنا ظهرت التنظيمات "الجهادية السلفية المقاتلة" " كالقاعدة" التي تبنت المسؤولية عن أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وكداعش (الذي تَسمّى أخيراً بتنظيم الدولة) والذي استولى على مساحة كبيرة من سوريا والعراق قبل انكساره في كلٍ منهما مع نهاية عام 2017، وغني عن القول أن هزيمة "السلفية الجهادية" لا تعني انتهاء وجودها كلياً إذْ ما زالت "قوات" و"خلايا" كثيرة لها في المنطقة العربية وخارجها (سوريا، العراق، اليمن، الصومال، مالي، أفغانستان..). ولكنها في الحقيقة ضَعُفت إلى درجة كبيرة، ولم تعد تشكل خطراً حقيقياً على المجتمعات والدول التي تتواجد فيها.
أمّا "الإخوان المسلمين" الذين مثلَوا تقليدياً الإسلام السياسي المعتدل، كما يظهرون علنا في أدبياتهم على الأقل، فقد تعرَض لانكسارات حقيقية في العقدين الأخيرين في المنطقة العربية، حيث انتهى حكم الرئيس الإخواني المصري "محمد مرسي" بعزله من قبل الجيش بل باعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2013، وقد لحقت السعودية بمصر في ذلك في عام 2014، والإمارات العربية المتحدة في عام 2015، أما في تونس فقد خسرت "حركة النهضة" وضعها باستيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في عام (2019) ووضعه رئيس الحركة (راشد الغنوشي) في السجن، كما خسر الإخوان الانتخابات (بزعامة عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني) في المغرب لصالح حزب "الاستقلال" والأحزاب الأخرى، ولا ننسى طبعا خسارة الإسلام السياسي في السودان، حيث كان الرئيس السابق (عمر البشير) رئيس " المؤتمر الوطني" ذا اتجاهات إسلامية واضحة، وقد كانت الخسارة الكبيرة الأخيرة لهذا التيار السياسي الإسلامي حل جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، واعتبارها جماعة غير شرعية ومُساءَلة كل من ينتمي إليها، برغم العلاقة التاريخية والخاصة بين الإخوان والنظام السياسي الأردني، ولمدةٍ زادت عن ثمانين عاماً.
إنّ طبيعة هذه المسيرة للإسلام السياسي (الجهادي السلفي المقاتل والمعتدل) يجب أن يدعو إلى التفكير والتساؤل: لماذا واجه الإسلام السياسي كل هذا التعثر برغم أنه يستمد طروحاته - كما يقول- من ثقافة الأمة ودينها السائد؟
إنّ هنالك العديد من الأسباب التي قد تعلَل هذه الظاهرة وقد نلخصها على النحو الآتي:
أولاً: اعتماد الإسلام السياسي أسلوب " الأسْتَذة" في الطرح، واعتبار أن ما يدعو إليه هو مما "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" كما يقولون، باعتبار أنه مُسَتمد من الدين، ولا مجال لمناقشة الدين وإلا وصل الأمر إلى حدود "الزندقة" و"الكفر"!
ثانياً: النظرة "الماضوية" فهم يريدون تطوير المجتمع الحديث لكي يكون على غرار المجتمع الإسلامي القديم متجاوزين في ذلك حقائق العصر، وتغير الظروف والأحوال، وتقدم التكنولوجيا، وغير ذلك مما يستوجب التوفيق الذكي والحصيف بين ثوابت الدين الحنيف، وطبيعة العصر ومتغيراته.
ثالثاً: القفز عن "البُعد الوطني" إلى "البعد العالمي" فيما يتعلق بمرجعيتهم فهذا التيار السياسي لا يؤمن بالأوطان والحدود بين الدول الإسلامية وذلك من منطلق وحدانية الأمة الإسلامية، وغني عن القول أن تيارات " الإخوان المسلمين" في كافة البلدان التي تتواجد فيها، تعتبر أنّ مرجعيتها النهائية هي " التنظيم العالمي" أو " الدولي" الذي يوجه الإخوان في كافة البلدان والدول، ويعمل على استعادة " الخلافة الإسلامية"، متناسيين أنه لم يعد بالإمكان قيام دولة دينية في العصر الحديث، وأنه من المتعذر واقعيا، توحيد ما يقارب "ملياري مسلم" في دولة واحدة، ولعلّ هذا السبب بالذات هو الذي أدى إلى خسارة "الإخوان المسلمين" مكتسباتهم في مصر، حيث انتماء المصريين لوطنهم العريق قوي وراسخ.
رابعاً: معاداتهم للديمقراطية (حكم الشعب)، وإيمانهم بالشورى التي لم تتبلور تاريخياً في العالم الإسلامي في صورة آلية "ديمقراطية" يتم الرجوع من خلالها إلى جماهير الشعب، والتي تضمن الخلاص من الاستبداد السياسي، والمحافظة على حقوق الإنسان، وغير ذلك من مفردات "المنظومة الإنسانية" التي أجمعت عليها كافة شعوب العالم، وترجمتها في مواثيق الأمم المتحدة. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن الإسلام السياسي المتمثل في الحركات الجهادية السلفية لا يؤمن أصلا بالديمقراطية، أما التيار السياسي المعتدل فهو يتظاهر بالإيمان بها، وقد يشارك أحياناً في فعالياتها ولكنه في الواقع يعبّر عن نزعة إقصائية واضحة، عندما تتاح له الفرصة، وهو يعتبر أن مرجعيته هي "مكاتب الإرشاد الإخوانية" وليس الجماهير الشعبية.
هل معنى هذا التحليل أنّ "الإسلام السياسي" قد انتهى في المنطقة العربية والإسلامية؟ بالطبع لا، إنه قد تعرض لانتكاسات حقيقية لا يستطيع التغافل عنها، ولكن من واجبه في الواقع. - وعلى صعيد مفكريه ومنتسبيه- أن يعيد النظر في أطروحاته ومسلماته، لكي يعبر في رؤيته السياسية عن "الطموح" الإسلامي، وعن "روح العصر" في نفس الوقت؟ وإن يؤمن بصدق حقيقي عن قبوله بالديمقراطية (حكم الشعب) كآلية لحل الاختلاف مع التيارات السياسية الأخرى، وأن ينطلق في رغبته في التغيير من "احترام" للوضعية القانونية لكل بلد يتواجد فيه وصولا إلى التغيير السلمي الذي لا عنف فيه ولا دماء.
هل هذا ممكن؟ سؤال يظل برسم الإجابة!